الصين في الحرب الهندية-الباكستانية: الدوافع، التأثير والنتائج
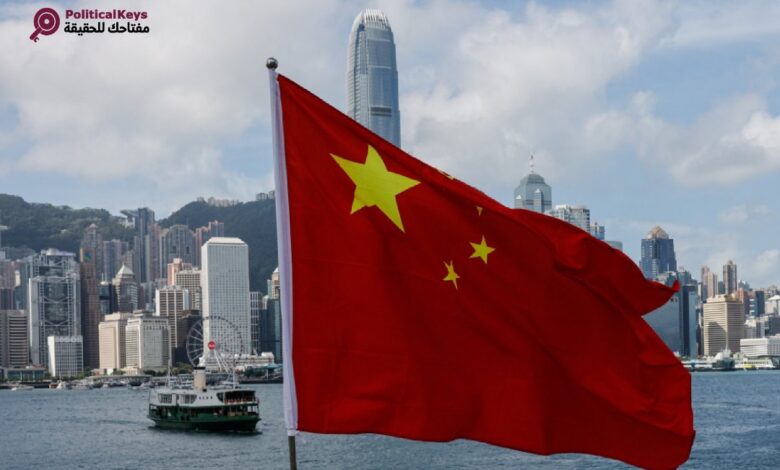
خلدون عبد الله – ماجستير دراسات استراتيجية ودفاع من جامعة “مالايا” الماليزية، مهتم بقضايا الأمن الدولي والعلاقات الدولية، وباحث غير مقيم في مركز “آسيا والشرق الأوسط للدراسات والحوار”.
كانت كزمولوجيا الصراع في شبه القارة الهندية ملازمة لنشأة الكيانات السايسية في المنطقة بالتزامن مع خروج الاستعمار البريطاني، ومثّل إقليم جامو-كشمير (المعروف اختصاراً بكشمير) خط التماس الحرج بين طرفي الإقليم (الهند وباكستان)، وعلى مدى ثمانية عقود من الصراع ظل ميزان القوة المركب بين التقليدي والنووي – منذ العقد التاسع في القرن المنصرم – تميل كفته باتجاه نيودلهي بصورة شبه مستدامة.
بالرغم من ذلك، كان الصراع الأخير بين الجارتين انقلاباً عسكرياً وجيوسياسياً، تجلّى فيه دور العامل الصيني الفارق في ترجيح الكفة الباكستانية من خلال الشراكة العسكرية متعددة المستويات. بيكين التي تقيّم علاقتها بإسلام آباد في سياق استراتيجيتها الكبرى ووفق محددات جيوستراتيجية وجيوقتصادية، تنظر إلى الحرب الدائرة بذات المحددات، وكذا في كونها اختباراً للصناعة العسكرية الصينية، ومكانتها في أسواق التسليح العالمية في مقابل التصنيع الغربي المكافئ. ما يجعل الحرب أكثر من مجرد جولة في صراع قديم، ولكن جزءً من التحول في توازنات النظام الدولي.
خلفية الصراع
تعود جذور الصراع في شبه القارة الهندية إلى تاريخ الاستقلال عن الاحتلال البريطاني 1947، ونشوء دولتي الهند وباكستان المتعاضدتين جغرافياً والمتنافرتين سياسياً. إذ مثلت الهند كياناً متعدد الأعراق والأديان، ولكن بصبغة هندوسية طاغية، بينما كانت باكستان أول تجل وستفالي لكيان سياسي مبني على قومية ذات بعد إسلامي. بين الجارتين، كان إقليم جامو-كشمير، ذو الأكثرية المسلمة والمحكوم من مهراجا هندوسي، خط تماس جيوسياسي وجيوثقافي ذكّى الصراعات والحروب بين الطرفين.
على مدى العقود المنصرمة تطور التوتر بين إسلام أباد ونيودلهي إلى صدامات مسلحة في مناسبات عدة، على غرار الحروب في 1947 و1965 و1971 ، (الأخيرة كانت الوحيدة التي لم تدر رحاها حول كشمير، وشهدت دعم الهند لأنفصال باكستان الشرقية وتأسيس بنجلاديش). وبحلول العام 1974 أقامت الهند أول تجاربها النووية – التي وصفتها بالسلمية – ليدخل الطرفان في سباق تسلح نووي، انتهى بحيازة الطرفين لسلاح الدمار الشامل مطلع التسعينات.
أسهم الردع النووي في خفض وتيرة الحروب وشدتها بين الجارتين، ولكن دون إنهاء حالة التوتر وجذور الصراع بينهما. إذ ظلت قضية كشمير غير محسومة، حتى بعد توقيع “اتفاقية شيملا” في يوليو 1972 التي رسمت خط السيطرة (Line of Control LOC) الفاصل بين حدود سيطرة الهند وبكاستان في إقليم كشمير. والذي عبّر في الحقيقة، عن حالة الأمر الواقع وتوازن القوة الذي يميل للكفة الهندية.
نتيجة لأسانيده الغير ثانبتة، ظل خط السيطرة عرضة للتخطي في كلا الاتجاهين، فدخلت الهند إلى المنطقة الباكستانية لاحتلال نهر سياشن 1984، في المقابل، حاولت باكستان إعادة ضبط الميزان وصناعة موقف استراتيجي مفضل من خلال دخول قواتها إلى منطقة الكارجيل ضمن حدود السيطرة الهندية في 1999، وفي كلا الصراعين آل الميزان الجيوسياسي للكفة الهندية.
بين تعقيدات ميزان القوة التقليدي، وخطورة التصعيد أبعد من سقوف الردع النووي، بدت الخيارات الباكستانية في التعاطي من التوسع الهندي في كشمير محدودة، وذهبت إسلام أباد في تبني استراتيجيات حرب الوكالة وتمرير الصراع بما يحول دون تمكين نيودلهي من إحكام سيطرتها على الإقليم.
في إبريل الماضي أعلنت “جبهة المقاومة” مسؤليتها عن هجوم استهدف سياحاً مدنيين – غالبيتهم من الهندوس- في مناطق السيطرة الهندية، وبررت الجماعة هجومها بأنه يأتي احتجاجاً على اعتزام الحكومة الهندية توطين 85 ألف ساكن جديد في المنطقة، ما ردت عليه نيودلهي بضرب مواقع افتراضية للجماعة في الأجزاء التابعة لباكستان، لينزلق الطرفين إلى حرب أخرى ولكن هذه المرة بمعادلة قوة مختلفة شهدت تفوقاً عملياتيا باكستانياً تلعب التكنولوجيا الصينية دور رأس الحربة فيه.
العلاقات الصينية – الباكستانية:
تمثل باكستان ركيزة جيوسياسية أساسية في استراتيجية الصين الكبرى على الصعيدين الجيوستراتيجي والجيوقتصادي. ففي المقام الأول، لا يخلو جو العلاقات الصينية-الهندية من التوتر المحتدم جراء الصراع الحدودي في التيبت الذي تطور هو الآخر في مواقف متنوعة إلى معارك منخفضة الشدة بين الجانبين. في هذا السياق، تلعب باكستان دور الموازن البديل، الذي بوسع بيكين تمرير الصراع إليه.
ولهذا سعت الصين إلى تمرير تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم وتصنيع القنبلة النووية إلى إسلام أباد لخلق توازن تهديد هندي-باكستاني، موازٍ للميزان الصيني – الهندي. وهو ما يمنح بيكين، بالإضافة إلى ميزة تمرير الصراع والميزان الموازي، امتيازاً جيوسياسياً آخراً في التقارب مع الجار الغربي للهند، والإحاطة بها بحرياً وقارياً.
على الجانب الآخر، ووفق المحددات الجيوقتصادية، تسعى قيادة الحزب الشيوعي إلى خلق طرق وممرات بحرية بين بحر الصين والمحيط الهندي تتجاوز معضلة مضيق مالاكا، المخنق الذي يؤرق صانع القرار في بيكين. في هذا المسعى، ورد مقترح شق وتعميق قناة كرا في تايلاند، وهو مقترح يصطدم بتحديات تقنية وسياسية جمّة. ولذا كان الحل الأمثل في تشييد ممر جوادار، الذي يتضمن شبكة طرق سريعة وسكك حديد من الأراضي الصينية إلى ميناء جوادار الباكستاني، بما يتيح نقل البضائع بحرياً دون المرور بالمخنق الاستراتيجي في خليج المالايو.
في ظل هذا التشابك بين مصالح الطرفين، تطورت العلاقات الصينية-الباكستانية إلى المستويات الاستراتيجية، لتغدو بيكين الشريك الأول لإسلام آباد، ليس على المستوى الاقتصادي وحسب، ولكن على الصعيد الأمني أيضاً، وذلك على ثلاث مستويات. المستوى الأول، التسليح المباشر، فبحسب إحصاءات مركز ستوكهولم الدولي للسلام، شكلت وارادات السلاح الصينية قرابة 81% من إجمالي التسلّح البكاستاني خلال الفترة 2020-2025 وتضمنت طائرات نفاثة، صواريخ، ورادارات وأنظمة دفاع جوي متطورة.
المستوى الثاني، نقل تكنولوجيا التصنيع العسكري، حيث تم تطوير العديد من الأسلحة الباكستانية إما بالتعاون مع شركات صينية، أو بواسطة تكنولوجيا وخبراء صينيين. المستوى الثالث، التدريب والتأهيل والمناورات العسكرية المشتركة، وذلك بابتعاث العديد من الضباط والأفراد في الجيش الباكستاني للدراسة والتدرب في الجامعات ومؤسسات التأهيل العسكري الصينية، على غرار جامعة الدفاع الوطني. كما أجرى جيشا البلدين مناورات جوية وبحرية وبرية مشتركة، تضمنت محاكاة سيناريوهات معارك، وتدريب أفراد في الجيش الباكستاني ضمن الوحدات العسكرية الصينية.
الأثر والنتائج
تجلّى العامل الصيني بصورة مباشرة في الحرب الأخيرة بين دولتي شبه القارة الهندية، من خلال انقلاب ميزان القوة التقليدي لصالح باكستان، ربما لأول مرة في تاريخ الصراع الممتد لحوالي 78 عاماً. ما دفع الهند إلى إعلان وقف إطلاق النار بصورة منفردة رغبة في حث باكستان على التهدئة وإنهاء الاشتباك.
حيث أفادت مصارد الجيش الباكستاني أن سلاح الجو الباكستاني، الذي يعتمد على طائرات جي- 10 سي الصينية، تمكن من إسقاط ثلاث طائرات رافال فرنسية وطائرة ميج-29 وسوخوي -30 روسية تابعة للجيش الهندي، خلال اشتباكات جوية امتدت لساعة وبقطر 160 كيلومتراً اشتبكت فيها 125 طائرة محاربة لكلا الجيشين.
على الجانب الآخر، بالنسبة لبيكين، التي لم تخض حرباً واسعة منذ أكثر من 50 عاماً، مثلت الحرب الدائرة فرصة ذهبية لتجربة فعالية تكنولوجيتها العسكرية في مواجهة التكنولوجيا الغربية المنافسة، وذلك على الصعيدين الأمني، والتجاري المتعلق بأسواق التسلح العالمية.
فبالرغم من عدم تعقيب الجيش الهندي على التصريحات الباكستانية بالنفي أو الإثبات، شهدت أسهم شركة تشينجدو الصينية – المصنّعة لطائرات جي 10 – ارتفاعاً بنسبة 17% في إغلاقات ” بورصة شينزن” يورم الأربعاء الموافق 7 مايو الجاري، ثم عادت لتشهد ارتفاعا أخراً بنسبة 20% يوم الخميس.
الطائرات المقاتلة ذات المحرك الوحيد، التي بدأ انتاجها في مطلع الألفية، وتصنّف فئتها (سي) – التي تحوزها باكستان- في المستوى 4.5 ضمن أخمسة أجيال من الطائرات النفاثة. أثبت جدارة عالية في مقارنة التكنولوجيا المنافسة، ولاسيما طائرات رافال من ذات الجيل. وهو ما يفتح المجال إلى رفع موثوقية التصنيع العسكري والتكنولوجيا الصينية، بما في ذلك الجيل الخامس من الطائرات النفاثة جي -20 التي تطرحها بيكين باعتبارها نظيراً لطائرت إف -35 الأمريكية.
على المستوى الجيوسياسي العريض، ينعكس تبدل توازن القوة في شبه القارة الهندية على ميزان القوة الأمريكي-الصيني، حيث تلعب الهند دوراً محورياً في التحالف الرباعي الأمريكي ضد الصين في نطاق الإندو-باسيفيك، كما ينعكس بصورة أخرى على تراجع النظام الدولي الليبرالي – المتهالك بسبب رئاسة ترمب وسياساته- في مقابل التعددية القطبية التي ترفع كل من بيكين وموسكو رايتها في المسرح العالمي.





